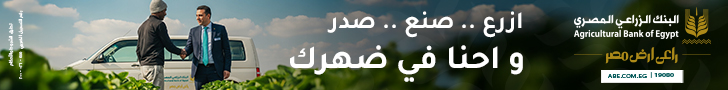الكُريات البلاستيكية.. المُلوث الخفي الذي يُهدد الحياة البحرية و الإنسان

تقرير : أحمد عبد الحليم
تُمثل الكُريات البلاستيكية الدقيقة، و هي حبيبات صغيرة لا يتجاوز حجمها حبة العدس، هي المادة الخام الأساسية لجميع المنتجات البلاستيكية، و تُعد أحد أخطر أشكال التلوث البلاستيكي في العالم. تُعرف هذه الحبيبات الصغيرة بـ “النردلز”، و تتسرب إلى البيئة بكميات هائلة بسبب سوء الإدارة التنظيمية على طول سلسلة الإمداد. و لا يقتصر خطرها على تلويث البيئة فيزيائياً، بل تعمل كناقلات سامة، حيث تمتص و تكثف المُلوثات الكيميائية الخطرة من المياه. هذا التسرب الروتيني يُفرض عبئاً إقتصاديًا و بيئيًا وصحيًا ضخمًا على المجتمعات، مما يُبرز الحاجة المُلّحة لتصنيفها دوليًا كمادة خطرة و فرض لوائح “منع الخسائر الصفرية” و تطبيق مبدأ “المُلوث يدفع”.
تقرير IPEN يكشف التسرب في 68% من المواقع.
تكشف بيانات “العد الدولي للكُريات البلاستيكية” التي نظمتها الشبكة الدولية للقضاء على المُلوثات (IPEN)، بالتعاون مع مُتطوعين من 14 دولة، عن تسرب هائل و عالمي لهذه الحبيبات إلى الممرات المائية. حيث تم العثور على الكُريات في 68% من المواقع التي شملها المسح، مما يؤكد أن المشكلة لا تقتصر على حوادث الشحن الكُبرى بل تُمثل فشلاً روتينياً في إدارة سلسلة الإمداد البلاستيكية من المنبع. هذه الكُريات لا تُشكل خطراً فيزيائياً على الحياة البرية فحسب، بل تعمل كناقلات سامة للمواد الكيميائية الخطرة، مما يتطلب إستجابة تنظيمية عاجلة و فَعّالة على المستوى الدولي.
الإطار الزمني و المنهجي.
تستند النتائج إلى جهود “العد الدولي للكُريات البلاستيكية”، وهو مبادرة ضخمة نُظمت من قبل الشبكة الدولية للقضاء على المُلوثات (IPEN) بالتعاون مع شبكات علمية متخصصة ومُتطوعين حول العالم. هذه المنهجية هي مثال بارز على “المراقبة المدنية”، حيث يقوم متطوعون في 14 دولة بمسح مواقع محددة على الشواطئ والممرات المائية لمدة زمنية موحدة (عادةً 10 دقائق) لجمع الكُريات البلاستيكية (التي يقل حجمها عن 5 ملم). وقد أسفر هذا الجهد المنهجي عن جمع ما يقرب من 50,000 حبيبة بلاستيكية، وهو ما أثبت – بحسب الخبراء في IPEN – أن تسرب الكُريات هو “فشل روتيني عالمي” وليس مجرد حوادث شحن عارضة. علاوة على ذلك، أكدت دراسات سُمّية إضافية أجرتها IPEN وشبكات بحثية أخرى، باستخدام عينات مجمعة من ما يصل إلى 23 دولة، أن هذه الكُريات تعمل كناقلات سامة لأنها تمتص وتكثف المُلوثات الكيميائية الخطرة من البيئة المائية، مما يرسخ خطورتها المزدوجة على الحياة البرية وصحة الإنسان.
حبيبات الموت الصغيرة.
تتفاقم أزمة التلوث البلاستيكي العالمية بفعل خطر خفي وكبير: “النردلز” (Nurdles) أو الكُريات البلاستيكية. هذه الحبيبات الصغيرة التي لا يتجاوز حجمها حبة العدس، هي المادة الخام الأساسية لجميع المنتجات البلاستيكية، و تُعد ثاني أكبر مصدر أساسي للتلوث البلاستيكي الدقيق (جسيمات أقل من 5 ملم). و تشير التقديرات إلى تسرب مئات الآلاف من أطنان هذه الكُريات إلى البيئة سنوياً بسبب سوء التخزين و النقل. و تَكْمُنْ خطورة هذه المشكلة في أنها تنبع من مرحلة ما قبل الإنتاج في الصناعات البتروكيماوية و التحويلية، مما يُؤكد وجود “ثغرات مُلّحة في التنظيم” تتطلب مُعالجة فورية للمساءلة عن هذا التسرب البيئي الصامت.
التسرب ظاهرة عالمية.
أكدت نتائج “العد الدولي للكُريات البلاستيكية”، و هو جهد عالمي للمُراقبة المدنية، أن تسرب البلاستيك الأولي يُمثل ظاهرة عالمية و ليست معزولة، و قد كشف المسح عن؛ الإنتشار الجغرافي الواسع بوجود الكُريات البلاستيكية في ما يقرب من ثلثي المواقع (68%) التي شملها المسح في 14 دولة يدل على أن التلوث يحدث بشكل مُتكرر و مُنتشر عبر سلاسل الإمداد العالمية. و قد جرى جمع ما يقرب من 50,000 حبيبة بلاستيكية من الممرات المائية خلال هذا العد، هذا بالإضافة إلى مصادر التسرب الروتينية، على عكس التركيز الإعلامي الذي غالباً ما ينصب على حوادث الشحن الكُبرى، و في هذه الصدد تجدر الإشارة إلى حادثة سفينة إكس – بريس بيرل في سريلانكا عام 2021، حيث تُعدّ هذه الحادثة هي الأكبر في التاريخ لتسرب الكُريات البلاستيكية. تؤكد هذه النتيجة بشكل قاطع أن البلاستيك قبل الإنتاج يتسرب بانتظام إلى الأنهار و البحيرات و السواحل. هذا التسرب يتم من خلال سوء إدارة روتيني يحدث في جميع مراحل سلسلة الإمداد البلاستيكية؛ بدءاً من مصانع الإنتاج و مروراً بالنقل وصولاً إلى مواقع التصنيع و إعادة التدوير. مما يرسخ فكرة أن الحد الأدنى من الإجراءات الإحترازية يتم تطبيقه للتحكم في هذه المواد.
العبء الإقتصادي لكُريات البلاستيك.
تُقدر التقييمات العلمية الحديثة أن الكمية العالمية المُتسربة من الكُريات البلاستيكية قد تصل إلى ما يزيد عن 230 ألف طن سنوياً في البيئة البحرية وحدها، مما يجعلها أحد أكبر مصادر تلوث البلاستيك الدقيق. هذا التسرب له ثمن إقتصادي باهظ؛ ففي حين تتحمل الحكومات و البلديات و مؤسسات تنظيف الشواطئ تكاليف إزالة هذه المواد، تُشير التقديرات إلى أن تكلفة تنظيف حوادث تسرب الكُريات الكُبرى تصل إلى ملايين الدولارات في كل مرة. هذا الفاتورة الباهظة تقع حالياً على عاتق دافعي الضرائب و المجتمعات المحلية، و تُبرز الضرورة المُلّحة لتطبيق مبدأ “المُلوث يدفع”.
الآثار و الأضرار المُترتبة.
يتخطى الأثر الإقتصادي لتلوث الكُريات البلاستيكية مُجرد تكاليف التنظيف، حيث تُقدر الأضرار السنوية على النظم البحرية عالمياً بـ 13 مليار دولار على الأقل. يقع العبء المالي الأكبر على قطاعي السياحة و مصائد الأسماك؛ ففي السياحة، يُؤدي التلوث إلى تنفير الزوار و زيادة نفقات تنظيف الشواطئ، مما يُقلل الإيرادات. و في مصائد الأسماك، تتضرر الإيرادات بسبب تلف مُعدات الصيد و تناقص المخزون السمكي نتيجة تلوث الكائنات البحرية. و تتفاقم هذه التكاليف في الحوادث الكُبرى؛ ففي كارثة سفينة إكس – بريس بيرل بسريلانكا عام 2021، تجاوزت التعويضات الأولية المدفوعة لأعمال التنظيف و تعويض الصيادين 150 مليون دولار، بينما قد تصل المُطالبات النهائية لمليارات الدولارات. هذه الأرقام تؤكد الضرورة القصوى لتطبيق مبدأ “المُلوث يدفع” لضمان عدم تحمل المجتمعات المحلية و دافعي الضرائب هذه الخسائر الباهظة.
مُلوث فيزيائي و ناقل كيميائي.
لا تقتصر خطورة الكُريات البلاستيكية على كونها مُجرد “مُخلّفات” في البيئة، بل إنها تُمثل مخزناً للمواد الكيميائية السامة. و تتجلى الخطورة العلمية لحبيبات البلاستيك في دورها المُزدوج كمُلوث فيزيائي و ناقل كيميائي سام، و هو ما تؤكده الدراسات العلمية التي أجرتها IPEN و شبكات بحثية أخرى في جانبين؛ الأول هو التخلص من المواد المضافة الأصلية، حيث تحتوي الكُريات البلاستيكية على مركبات كيميائية مُضافة عمداً لتعزيز خصائص البلاستيك، مثل مُثبِّتات الأشعة فوق البنفسجية، و مثبطات اللهب المُبرومة، و مركبات مثل البيسفينول أ، و قد أظهرت دراسات IPEN أن هذه المواد السامة يُمكن أن تنتقل إلى البيئة أو إلى الحيوانات التي تبتلعها، مما يرتبط بمخاطر صحية خطيرة كـاضطرابات الغدد الصماء و السرطان و تأثيرات على النمو المعرفي و الإنجابي. والجانب الثاني هو الإمتزاز أو الإمتصاص السطحي للملوثات، فهو عملية فيزيائية أو كيميائية تُشير إلى تراكم جُزيئات مادة معينة (تُسمى المُمتزّ) على سطح مادة أخرى (تُسمى المادّة المازّة). فنظراً لطبيعتها الكارهة للماء تعمل الكُريات البلاستيكية مثل الإسفنجة تمتص و تكثف المُلوثات العضوية الثابتة (POPs) و المواد الكيميائية السامة الموجودة في مياه البحر و الأنهار، مثل المركبات العطرية مُتعددة الحلقات (PAHs)، و مبيدات الآفات، و المعادن الثقيلة. يُؤدي هذا الامتزاز إلى تضخيم تركيز هذه المواد على سطح الكُريات بمستويات أعلى بكثير من المياه المحيطة، مما يجعلها ناقلاً ساماً قوياً عند دخولها السلسلة الغذائية.
من المحيط إلى البشر.
يُعدّ التسرب الهائل لمئات الآلاف من أطنان “الكُريات البلاستيكية” سنوياً إلى البيئة كارثة بيئية ذات تداعيات و خيمة، حيث تتسبب هذه الكُريات في تسمم الحياة البرية و الإنسداد الفيزيائي لأجهزة الهضم؛ فالحيوانات البحرية و الطيور تخلط بينها و بين طعامها، ممّا يُؤدي إلى شعورها الكاذب بالشبع و موتها جوعاً. و الأخطر من ذلك، هو أن هذه الكُريات تعمل كناقلات للمُلوثات الكيميائية المركزة، التي تتحرر داخل أنسجة الحيوانات المُبتلعة، مُشكلةً بذلك مساراً للسموم عبر السلسلة الغذائية وصولاً إلى الإنسان.
المستنقعات تحجز آلاف الجُسيمات البلاستيكية.
كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا في أمريكا، و نُشرت في “نشرة التلوث البحري”، أن مُستنقعات المد و الجزر للمياه العذبة، و رغم أهميتها الحيوية للحياة البرية و حماية السواحل، إلا أنها تعمل كأحواض لتجميع الجُسيمات البلاستيكية الدقيقة، و وجد الفريق أن هذه المُستنقعات تحتجز كميات كبيرة و مُتنوعة من كُريات البلاستيك، مع تزايد تركيزاتها و مخاطرها البيئية في إتجاه مجرى النهر، كما أن البوليمرات الأكثر خطورة، كالجزيئات الكبيرة الموجودة في البلاستيك أُحادي الإستخدام، تُشكل مخاطر بيئية جسيمة. في هذه الدراسة، حلل الباحثون رواسب من محمية جون هاينز الوطنية للحياة البرية الواقعة خارج فيلادلفيا، و هي أكبر مُستنقعات المد و الجزر للمياه العذبة المُتبقية في ولاية بنسلفانيا، وحددوا 4590 جُسيمًا من البلاستيك الدقيق و 29 نوعًا من البوليمرات، و كانت البولي بروبيلين و البولي يوريثان و مطاط الإطارات هي الأكثر شيوعًا.
الفشل التنظيمي العالمي.
يتزايد الخطر البيئي و الإنساني لـلكُريات البلاستيكية بسبب التنظيم الدولي المُتراخي؛ حيث أن عدم تصنيفها كمادة خطرة ضمن إتفاقيات رئيسية مثل ماربول يُبقي التعامل الآمن معها طوعيًا أو محليًا. هذا التقاعس العالمي الروتيني، كما وثقته دراسة IPEN، له تداعيات إنسانية و مباشرة؛ ففي كارثة سفينة إكس-بريس بيرل بسريلانكا، وصف العمال المُتضررون الكُريات بأنها “دمّرت طريقة حياتهم بأكملها”، مُحمّلةً المُجتمعات المحلية العبء الكامل للخسائر الاقتصادية والصحية، مما يُبرز الحاجة المُلحة لتصنيف دولي فوري ومُلزِم لهذه المادة.
الرد الطوعي للصناعة.
في مواجهة الإتهامات بالفشل “الروتيني عالمي”، تعتمد الصناعة على مُبادرات طوعية ذاتية التنظيم، أبرزها برنامج “التنظيف الشامل”، لمنع تسرب الكُريات. ومع ذلك، تُثبت الأدلة الميدانية التي جمعتها الشبكة الدولية للقضاء على المُلوثات IPEN أن الإعتماد على هذا الإطار غير المُلزم هو السبب المباشر لاستمرار التسرب الهائل و العالمي. هذا التناقض يؤكد أن الإجراءات الطوعية للصناعة غير كافية، وتستخدم كذريعة لتجنب اللوائح الإلزامية الضرورية لحماية البيئة.
ضرورة التنظيم و الحلول.
تؤكد نتائج مسح IPEN على أن الجهود الحالية لمُكافحة التلوث البلاستيكي، و التي تركز بشكل أساسي على مُعالجة المُخلّفات بعد الإستخدام، غير كافية. تتطلب هذه الأزمة حلولًا في المنبع، أي في مرحلة ما قبل الإنتاج. يدعو المدافعون و الخبراء في IPEN إلى، الرقابة الصارمة عند المصدر (منع الخسائر الصفرية)، حيث يجب فرض لوائح دولية صارمة تُلزم الشركات المُصنعة و المشغلين في جميع مراحل سلسلة الإمداد بتطبيق إجراءات “منع الخسائر الصفرية” لضمان إحتواء الكُريات بالكامل. هذا إلى جانب مبدأ “المُلوث يدفع” (المسئولية المُمتدة للمُنتج)، حيث يجب تحميل مُنتجي البلاستيك المسئولية الكاملة عن تمويل تنظيف الآثار البيئية و الصحية الناتجة عن تسرب منتجاتهم. بالإضافة إلى معاهدة دولية شاملة، حيث يتطلب الأمر إبرام مُعاهدة دولية لمُكافحة التلوث البلاستيكي تهدف إلى تقليل الإنتاج البلاستيكي بشكل عام، و حظر إستخدام المواد الكيميائية الخطرة في البلاستيك، و ضمان الشفافية بشأن المُكونات الكيميائية للمنتجات البلاستيكية.
دور المجتمع و المستهلك في المُكافحة.
على الرغم من أن أزمة الكُريات البلاستيكية هي في جوهرها فشل تنظيمي على مستوى الصناعة و المنبع، إلا أن المجتمع المحلي و المستهلك يمتلكان أدوات ضغط حاسمة لتعزيز الحلول. يَكْمُنْ الدور غير المباشر للمجتمع في الضغط الفَعّال على الشركات المحلية و الدولية لضمان الإلتزام الصارم بمعايير “صفر خسارة”. يمكن تحقيق ذلك عبر دعم و مُطالبة الجهات التشريعية بفرض قواعد “المُلوث يدفع”، إضافة إلى المشاركة النشطة في مبادرات المُراقبة و العد المدني (مثل “العد الدولي للكُريات البلاستيكية” الذي نظمته IPEN). هذه المُبادرات توفر بيانات موثوقة ومُثبتة عن مواقع التسرب، و تحول المشكلة غير المرئية إلى دليل علني و مُوثق، مما يُلزم الحكومات و الهيئات التنظيمية باتخاذ إجراءات عاجلة و فَعّالة ضد المُمارسات الصناعية المُتراخية.
الحلول لمنع الخسائر الصفرية.
لضمان فَعّالية التوصيات التشريعية لشبكة IPEN، يجب على اللوائح الدولية أن تفرض حلولاً فنية صارمة لتحقيق هدف “منع الخسائر الصفرية” في مرحلة ما قبل الإنتاج. يتطلب ذلك خطوتين رئيسيتين: الأولى، إحتواء المصدر المادي، و ذلك بإلزام مصانع الإنتاج بتركيب مُرشحات مُتناهية الصغر و مصائد شبكية على جميع منافذ الصرف و نقاط تجميع مياه الأمطار، لضمان إلتقاط الكُريات قبل تسربها إلى البيئة المائية. و الخطوة الثانية، هي تعزيز أمان النقل والتتبع، وذلك بفرض معايير دولية لإستخدام أكياس و حاويات مُحكمة الإغلاق و مقاومة للتمزق أثناء النقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق نظم التتبع الإلكتروني (GPS/RFID) على الشحنات لتحديد مصدر أي تسرب يحدث بسرعة و محاسبة المسئولين فوراً، مما يحد من الكوارث و التسربات الروتينية.
مضخّمات لأمراض خطيرة.
من منظور علم السموم، يُؤكد الخبراء الكيميائيون أن هذه الكُريات تُشكل خطراً مُضاعفاً يتعدى الخطر الفيزيائي على الحياة البرية. فمن ناحية، تتسرب منها مواد كيميائية خطرة مُضافة عمداً، مثل مُثبطات اللهب المُبرومة (BFRs) والبيسفينول أ (BPA)، و التي أثبتت الدراسات إرتباطها باضطرابات الغدد الصماء و السرطان. و من ناحية أخرى، بفضل طبيعتها الكارهة للماء، تعمل الكُريات مثل إسفنجة شديدة الكفاءة لتكثيف و تضخيم المُلوثات السامة الموجودة في المياه (مثل المركبات العطرية مُتعددة الحلقات)، محولة نفسها إلى ناقل سام قوي ينقل جرعات مُركزة من السموم إلى أنسجة الكائنات الحية عند إبتلاعها، مما يضمن وصولها إلى السلسلة الغذائية وصولاً إلى الإنسان.
المطالبة بتشريع عالمي وحظر كيميائي فوري.
يُطالب الخبراء و المدافعون في IPEN أولاً: بتحويل جذري للحلول نحو المنبع (ما قبل الإنتاج). و هم يدعون بقوة إلى فرض لوائح دولية صارمة تُلزم الشركات بتطبيق إجراءات “منع الخسائر الصفرية” و تفعيل مبدأ “المُلوث يدفع”. و ثانياً، ضرورة إبرام مُعاهدة دولية لمُكافحة التلوث البلاستيكي بهدف تقليل الإنتاج و حظر إستخدام المواد الكيميائية الخطرة فيه. كما يُشدد الخبراء على ضرورة إجراء أبحاث سُمية عاجلة لتقييم مدى تركيز هذه السموم في الموارد الغذائية البحرية التي تصل إلى البشر، لتقديم أساس علمي قاطع لفرض حظر شامل على المواد الكيميائية الخطرة المُرتبطة بالبلاستيك.
يوضح مسح IPEN أن الكُريات البلاستيكية ليست مُجرد مشكلة “نظافة” محلية، بل هي قضية تنظيمية عالمية تكشف عن فشل الصناعة في السيطرة على موادها الأساسية. أن التحدي يَكْمُنْ الآن في تحويل هذه الأدلة العلمية الموثوقة إلى إجراءات تنظيمية عاجلة و فَعّالة قبل أن تتفاقم أزمة التلوث الكيميائي البيئي بشكل لا يُمكن السيطرة عليه.
مسئولية المُنتج و تعزيز الوعي و التعاون.
يتوافق موقف جمعية المكتب العربي للشباب و البيئة (AOYE) وهي من أوائل الجمعيات الأهلية في مصر التي أولت إهتمامًا مُبكرًا لقضية التلوث البلاستيكي، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي و الدولي باعتبارها عضوًا في الشبكة العربية للبيئة و التنمية (RAED) مع الحلول التنظيمية الصارمة التي دعت إليها دراسة IPEN لمُكافحة التلوث البلاستيكي.
وقد تجلّى هذا الموقف في الدعم القوي الذي قدّمه المكتب العربي لتطبيق قواعد “المسئولية المُمتدة للمُنتج” (EPR) على أكياس التسوق البلاستيكية في مصر، بالتعاون مع وزارة البيئة.
ويؤكد الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب و البيئة، أن هذا القرار يُعد خطوة جوهرية لأنه يُلزم مُنتجي البلاستيك بتحمّل التكلفة الكاملة للتخلص الآمن من مُخلّفاتهم، و هو ما يُمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ “المُلوِّث يدفع”، و يحفّز الشركات على التحول نحو البدائل الصديقة للبيئة، مما يفرض ضغطًا تنظيميًا إيجابيًا على مراحل الإنتاج من المنبع. كما يولي المكتب العربي إهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي و التعاون المجتمعي في مُواجهة مخاطر البلاستيك غير القابل للتحلل. فقد دعا المكتبُ الشركات و المستهلكين إلى تبنّي سلوكيات بيئية مسئولة، و حثّ جميع الأطراف المعنية – من حكومات و قطاع خاص و مجتمع مدني – على توحيد الجهود لتحقيق أهداف بيئية مستدامة.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب العربي العديد من المُبادرات البيئية، كان آخرها مُبادرة “لا للبلاستيك”، التي ما زالت تحقق نجاحات ملحوظة على مستوى محافظات مصر، من خلال التعاون مع المنتديات المحلية للتنمية المستدامة. و بذلك يؤكد المكتب العربي أن جهوده لا تقتصر على الإطار التشريعي و التنظيمي، بل تمتد لتشمل الجانب التوعوي و التشاركي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإستجابة الشاملة لأزمة التلوث البلاستيكي.
خبيرة أممية تدعو لوقف إنتاج البلاستيك المُلوِّث.
أكدت الدكتورة سامية جلال سعد، الأستاذة بالمعهد العالي للصحة العامة بالإسكندرية و الخبيرة الإستشارية لدى الأمم المتحدة في البيئة، على أهمية الإلتزام بالإنتاج الأنظف الذي يحد من إنتاج هذه الكُريات السامة داخل العملية الصناعية بالبحث عن مُنتجات يقل فيها المُكونات البلاستيكية للإقلال من إستخدامها عند المنبع؛ فبالرغم من أهميتها للتعبئة و الصناعة، إلا إن ثباته الكيميائي و عدم الإستفادة من نواتجه الثانوية يُؤدي إلى تراكم كُريات البلاستيك السامة و إنتشارها في كل الأوساط البيئية، لافتة إلى أن هذا التلوث ليس مُجرد عبء على الإقتصاد فقط، بل أصبح مصدرًا لأمراض غريبة التي تُصنف غالبًا كمناعية أو غير مُحددة المُسببات، منوهة على ضرورة التحول نحو “الإنتاج الأنظف” لتقليل المُكونات البلاستيكية و الحَدّ من إستخدامها من المنبع.
كما دعت الدكتورة سامية، الدول المُتقدمة إلى ضرورة البحث عن إنتاج مواد تغليف و تعبئة بديلة للحَدّ من تصنيع الحبيبات البلاستيكية الضارة، مُؤكدة أن تدهور البيئة ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود السياسية و تتجلى في تغير المناخ الذي يُؤثر على الجميع دون إستثناء، مُتسائلة؛ عما إذا كان سيتم وقف إنتاج البلاستيك المُعتمد في تصنيعه على البترول كإجراء للحَدّ من الظواهر الصحية الباهظة التكلفة التي تتحمل أعباءها الدول، لا سيما النامية و الفقيرة، مُنتقدة تصدير الدول الغنية للمُخلّفات البلاستيكية تحت مسمى “مستلزمات إنتاج”، مُشيرة إلى أنه كان الأجدر أن يتحمل المُستخدم ضريبة رفاهية إستخدامه للعبوات و المستلزمات وحيدة الإستخدام، كما رأت الخبيرة البيئية أنه ينبغي على الدول الغنية حرق مُخلّفاتها و الإستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة، خاصة و أنها تدعو إلى ترشيد إستخدام الوقود الأحفوري كجزء من مبدأ خفض البصمة الكربونية و مُكافحة التغيرات المناخية.
و طالبت الخبيرة الإستشارية لدى الأمم المتحدة في البيئة، بخطوات جادة لمُكافحة التلوث البلاستيكي، تبدأ بمنع إستيراد المُخلّفات البلاستيكية من الخارج و الإستفادة القصوى من البلاستيك المنتج و المُستخدم محلياً، مُنتقدة إحجام الدول الغنية عن إستخدام التقنيات الحرارية المُتقدمة كـ “البيروليسيز” و”الجاسيفيكيشن” للتخلص الآمن من مُخلّفاتها لخفض التكلفة، داعية إلى تقوية منظومة الفصل من المنبع على المستوى المحلي، مُؤكدة على أن هذا يتطلب جهداً إعلامياً مُكثفاً لتوعية المجتمع الذي أظهر إستجابة إيجابية لجمع المُخلّفات القابلة للتدوير نظراً لدورها في تحقيق دخل مادي.
و أضافت الدكتورة سامية، أن الإعتماد على العبوات الزجاجية القابلة لإعادة الملء في منتجات المشروبات الغذائية كان نموذجاً ناجحاً جداً للحَدّ من تراكم الكم المُتزايد من المُخلّفات، و يُمكن تطبيقه على كافة المُنتجات الإستهلاكية التي تستخدم عبوات بلاستيكية أُحادية الإستخدام، مثل المُنظفات و مُستحضرات التجميل، من خلال نظام إعادة تدوير (أو إعادة إستخدام) يعتمد على حافز مادي للمُستهلك، مُؤكدة أن هذا التحول يتطلب تغيير خطوط الإنتاج، مما يجعل فرض رسوم على الحاويات البلاستيكية ذات الإستخدام الواحد دافعاً قوياً و حاسماً لإلزام الصناعة على تبني نُظم أكثر إستدامة و أقل إنتاجاً للحبيبات البلاستيكية السامة المُلوثة للبيئة.
كارثة تحتاج حلول فورية.
لقد أوضحت البيانات العلمية المُستخلصة من مسح IPEN و الدراسات المُرتبطة به حقيقة محورية؛ أن تسرب الكُريات البلاستيكية ليس حادثاً عارضاً، بل هي فشل روتيني في إدارة البلاستيك الأولي عالمياً. هذه الدراسات لم تكتفِ بتوثيق إنتشار هذه الحبيبات باعتبارها مُجرد مُخلّفات عابرة، بل كشفت عن وظيفتها كناقلات كيميائية سامة تُهدد الحياة البرية و البحرية و صحة الإنسان بتراكمها المُنتظم في البيئة. بناءً على هذا التوثيق العلمي، أصبح التحول الفوري نحو الحلول من المنبع (مرحلة ما قبل الإنتاج) أمراً حتمياً يتجاوز جهود التنظيف التقليدية. هذا يتطلب إجماعاً دولياً لفرض إجراءات تنظيمية صارمة، تشمل لوائح “منع الخسائر الصفرية” و تفعيل مبدأ “المُلوث يدفع” لإلزام المُنتجين بتحمل تكاليف الأضرار. كما أن التحدي الأكبر الآن هو ترجمة هذه الأدلة الموثوقة إلى تشريع عالمي عاجل لحماية البشرية من حرب السموم التي تشنها “حبيبات الموت الصغيرة” و هي الكُريات البلاستيكية المنتشرة في البيئة.