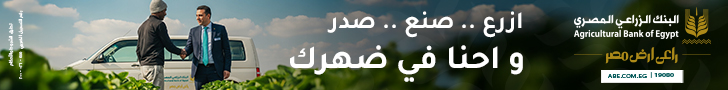رئيس اتحاد الوطن العربى الدولى يتحدث عن الحقوق والحريات

بقلم / المفكر العربى الدكتور خالد محمودعبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
و رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
مما لاشك فيه أن من أكبَرِ مَظاهر عظمة الدِّين الإسلامي: أنَّه راعى التجاذُبات والتَّنافرات النفسيَّة ما بين الإِنْسان من حيث كونُه إنسانًا له احتياجات عاطفيَّة وشخصيَّة وفطرية، وحُرِّيات يسعى لتحقيقها، وبين كونه ضلعًا وحجرًا أساسيًّا في بناء المُجتمع وتشييد الحضارة، فلَمْ يبالغ هذا الدِّين في رسم الصُّورة النمطية للحضارة القائمة عليه، وتكليف الإنسان بِبِناء مجتمعه وتنمية بلاده، مهمِّشًا بذلك الفرد وحقوقه ومتطلَّباته الأساسية، ولكنه اهتمَّ اهتمامًا بليغًا بحقوق الأفراد وكفالة الحريات المختلفة له ولأبنائه، وجعل ذلك مدخلاً أصيلاً وباحة رئيسة لِصَرح الحضارة والتنمية، حيث لا يشيد العبيدُ صروحَ الحضارات، وإنَّما الذين يشيدونها هم الرجال الأحرار، أربابُ العِزَّة والأنَفة، والثِّقة في خير دينٍ ختَم الله تعالى به الرِّسالات، وأرسَل من أجْله خير الرسل.
لذا؛ فإنَّ كبْتَ الحريات، وقهْرَ الرجال، ومنْعَهم حقوقهم الأساسية هو أقوى مَعاول هدم المُجتمعات الإنسانيَّة بشكل عامٍّ، وهو أكبَرُ عوامل الانْحِطاط والتخلُّف الَّتِي تُقاسي منها البشريَّة المعاصرة؛ لذا فإنَّ الدعوة إلى الإسلام والالتزام به وتحكيمه بين العباد ليست دعوةً ساذجة بالصُّورة التي يُصَوِّرها معتنقو التصوُّرات البشرية الزائفة، وإنَّما هي دعوة في صميم الإصلاح البشريِّ، ودفْع الظُّلم ورفع التخلُّف والرَّجعية عن كواهل البشر.
لقد قاست البشريَّة العمشاءُ خلال عقود طويلة من أعمارها من تَجارب ومناهج بشريَّة قاصرة، كانت تولِي اهتمامًا بأنواعٍ من الحقوق على حساب أنواعٍ أخرى، فهي حينًا تُقدِّس الفرد وتَعبُده وتعطيه أكثر مِمَّا يستحقُّ، فيكون ذلك على حساب المجتمع، فتقع الشُّعوب في أزمة فرديَّة، وتقديسٍ للذَّات، وتهميشٍ لبناء المُجتمعات، وحينًا آخر تُعْلِي من قدر المجتمع، وتَنْسى الفرد، فتَبْخسه حقوقه، فتتضاءل قيمة الفرد، ويصير مجرَّد ترس في عجلة الحياة، تنتفع منه الدَّولة وتَمَصُّ دماءه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، فإنْ مَرِض أو أعيق أُلْقِي في مزبلة النِّسيان… وهكذا تظلُّ الأُمَم تعاني وتقاسي الأمَرَّين، ولا تصل في نهاية الحال إلى نتيجة تسرُّ الناظرين.
لقد راعى الإسلامُ النَّزعة الفرديَّة في الفطرة الإنسانيَّة، فلم يتَجاهلها ولم يُهملها، بل عزَّزها وأعلى من قيمتها، ولكن ليس على حساب الجماعة الْمُسلمة، بل جعل توازنًا فريدًا بين كلا النَّزعتَيْن، عزَّ نظيرُه في الأنظمة البشرية الوضعيَّة القديمة والمعاصرة، فمهما أوتِيَ واضعو الأنظمة والمناهج والقوانينِ مِن علْمٍ فإنَّ علمهم هذا يظلُّ قاصرًا مقارَنةً بعِلْم الله تعالى المُحيط، فقد يصيبون الفرد في مقتله، ويضرُّونه من حيث يظنُّون فيه النَّفع، فالتشريعات التي تأخذ جانب الرِّجال ربَّما كانت على حساب نساء المُجتمع فتضرهن، وما كان منها في جانب النِّساء ربَّما جاءت على حساب الرِّجال فتضرهم، وما كان منها في جانب الفرد أضرَّ بالمُجتمع، وما كان منها في جانب المُجتمع أضرَّ بالفرد ومَصالحه وحُرِّياته، وهكذا، فهي حالةٌ من الاضطراب وتضارب الْمَصالح والمنافع بين المخلوقين، والضَّحية في النِّهاية هي الأُمَّة بأفرادها وجَماعاتها، ورجالِها ونسائها، وهذا شأن التخبُّط لا يقرُّ له قرار، ولا يستمرُّ على حال.
أمَّا دين الله تعالى فقد راعى الجميعَ دون حيفٍ أو ضَيم أو ظُلم، ودون تقديمٍ لأحد الأطراف على الآخر، بل راعى مصالح الجميع بِما يتناسب مع المصلحة العامَّة للمجتمع، وهذا بناءً على علم الله تعالى المُحيط بالكائنات: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، فوحْيُه ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42]، والسُّنة النبوية المشرَّفة جزءٌ لا يتجزَّأ من ذلكم الوحي: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3 – 4]، فهما وحْيَان من مشكاةٍ واحدة لا تُحابي أحدًا .
لقد آمنَتِ الأُمَّة الإسلامية بِحُقوق أبنائها منذ القديم، فكفَلَت لَهم حقوقًا تتضاءل بِجانبها الحقوقُ التي استحدثَتْها الأنظمة الوضعيَّة القاصرة، واستمدَّت من تعاليم الإسلام العظيم مبادئَ تُعْلِي من قيمة الفرد، وتعوِّل عليه في قيام النهضة، وتعتَمِد عليه في تشييد الحضارة؛ لأجْل ذلك كان لا بدَّ لِهذا الكائن المكرَّم أن تُتاح له مساحاتٌ من الإبداع والبناء لَم تُتَح لأحدٍ قبْلاً، بدءًا من حُرِّية انتقاد إمام المسلمين وخليفتهم، والإنكار عليه، وتذكيره بالحقِّ، ومقاومة فساده، وانتهاءً بِحُقوق الطِّفل بين أفراد أُسْرته وفي مُجتمعه، مرورًا بكفالة حُرِّيات الرَّأي والاجتهاد، والتملُّك والعمل، إلاَّ أنه – الإسلام – صيانةً لِهذه الحريات العامَّة أحاطها بسياجٍ من التقييد بِمبدأ المُحافظة على حقِّ الغير، سواءٌ أكان هذا “الغير” فردًا أم جَماعة، فما يؤدِّيه الفَرْدُ من تكاليفَ إزاءَ الآخرين فهي في حقِّه تكاليفُ وواجباتٌ، وفي حقِّ غيره حقوقٌ وحُرِّيات، فمنشؤها التَّكليف الذي يتنافى مع الإطلاق في استعمالها؛ إذْ لا حرية مع الفوضى، ولا فوضى مع الحرِّية المسؤولة.
فالحريات العامَّة مَصُونة، إلا أنَّه ملاحَظٌ فيها حقُّ الغير من الفرد والمُجتمع؛ صيانةً لَها وتحقيقًا للتَّوازن بين الْمَصالح الفرديَّة والحُرِّيات الْمُتعارضة، وهذا مِن أبرز خصائص هذا الدِّين عدلاً ومصلحة، فيما لَم تتمَكَّن بقيَّة الأنظمة الوضعيَّة من تحقيق هذه الْمُعادلة الصَّعبة على أرض الواقع، وإن كانت حقَّقت أحيانًا نوعًا من الإبْهار التنظيري في المؤلَّفات والأبحاث والدساتير النظرية.
إنَّ الإسلام لا يستمدُّ قوَّتَه وعظمته من مُجرَّد تشريعاتٍ نظريَّة، أو مفاهيم ذهنيَّة مجرَّدة، أو مبادئ فلسفيَّة يدعمها المنطق والعقل فحسْب، وإنَّما
لِنَشره بين الناس.. المسلمين منهم وغير المسلمين.